المختنقون..
سنة النشر : 01/05/2009 الصحيفة : الاقتصادية
.. لم أقض ِمع أختي وقتاً مجدياً في زيارتي القصيرة، لقد كان الهاتفُ معلقا على أذنها، وكل علائم الحزن والاهتمام والحيرة والحرج واضحة كل الوضوح على ملامحها. فهمت فيما بعد أن من كانت على الطرف الآخر زوجة بائسة ومحطمة وهي من بلد شقيق تزوجت سعوديا يعاني عجزاً خلقياً، على أن الرجلَ المعدمَ الضعيفَ كان جلف القلب، سوداوي الطباع، يغيب عن عقله مما يحتسيه، ثم يضربها ضربا مبرحا. ولما كانت أختي من المتطوعات العاملات، فإن المرأة تأتي وتشتكي بأن زوجها يسرق المال القليل الذي تحصل عليه من معوناتهم، بعد أن يكون قد ضربها الضرب الثقيل.. في آخر مرة جاءت الشرطة، وأبعدت الرجل. على أن المرأة كانت تحادث أختي لتخبرها عن أعمال أشد فظاعة، لتقول: إن زوجي أبُـْعـِد، وظننت أنه المتنفس والخلاص.. ولكن الذي ضربها ضربا مبرحا هذه المرة وسرق نقودها هو ابنها ابن الثانية عشر!! ولهذه المرأة ولد كبير، ولكنه هجر المنزل من سنين ولم يعد يعرف أهله ويتجنب أمه كما يتجنب الوباء.. هذه المرأة لا شبكة نجاة تحتها، لا بيت أهلٍ ترجع إليه، وحيدة بلا رافد ولا معين، ثم أن لا جهة تذهب إليها حتى لا يطير ما تبقى من عقلها، وما تهاوى من صحتها.. إنها فقط تريد الهواء، تريد أن تتنفس.. تريد أن تتكلم.. حتى لا تختنق.
وتأتيني رسالة من سبع صفحات على بريدي من صبي ذكي، طلي الأسلوب، حلو العبارة، بالغ التهذيب، في الثالثة عشر من عمره، ويعنون رسالته بالعنوان الآسر للفؤاد: بابا نجيب. والولد يحكي تراجيديا يومية متوالية ومتكررة وكأنه العذاب الذي نذرته آلهة الإغريق على "سيزيف".. عذاب لا ينتهي إلا ليبدأ. والولد ضحية ظروف متجمعة من القهر، وسوء البيئة، وكتامة الإهمال، وضياع الحب.. توفت والدته فتزوج الأب عروسا صغيرة، وأحضر الأب أخاها ليكون بجوار أخته ودبر له عملا لخدمة أخته والمنزل. صارت هواية الزوجة المغناج الصباحية أن تركل الطفل بقدميها مع البصاق والشتم ليهرع في إحضار الخبز من الخباز الذي تفرضه عليه، فيضطر أن يمشي أكثر من ألف متر كل يوم متجاوزا خبازَيـْن ( لا تحبهما العروس المغناج) ليحضر لها الخبز المقدد، ولو نقص درجة من حرارته فإنه الصفع والبصق من جديد.. ثم أن الشابَ أخو العروس الطروب، يتفنن في ضرب الفتى ومصارعته والتطويح به وضرب رأسه بالجدار.. ليذهب بعد ذلك الطفل المهيض للمدرسة متأخرا، فتنهال عليه العِصي من المدير إلى المدرسين، ويتعرض للهزء والضرب من زملائه نظرا لشظافة مظهره الواضحة والكدمات التي تخفي عينيه، وتضخم من حجم شفاهه.. أما أبوه فهو كما قال: "لا يراني، وكأنني مت مع والدتي!".. يا ألله. هذا الطفل لم يترك اسما ولا عنوانا لمقر، إنما عنوان إلكتروني لم يجبني عليه، كل ما كان يريد هو أن يتكلم .. أن يتنفس، حتى لا يختنق.
ورسالة في بريدي أطول من الأخرى من فتاة ويسكنها الوجع والعذاب والطحن الهادر في داخلها ومن الخارج أيضا، فهي تكتب لي قصتها من وعت الدنيا إلى هذا اليوم، ووجعها مصدره أنها فتاة لم تكتمل أنوثتها بخلط جيني ذكري، فتبدو عليها مظاهر رجولية خشنة مثل الصوت، والشعر على الوجه، والتقاطيع الصلبة، بينما هي بالداخل زهرة عذبة ورقيقة وسيالة النعومة والأحاسيس.. إنها تقول:"لا لم أعد أكترث لما تقدحني به زميلاتي من أوصاف، مثل "العريس" أو " الجنية" ولكن الذي يمزق أوتار قلبي ويهدني ذرات وأجزاء هن البنات اللاتي يخفن مني ويرتجفن عندما أكون بالمصادفة قربهن رغما عنهن".. أما ما تعانيه الفتاة في الكلية وفي البيت، ومن الوساوس، ومن الوحدة الموحشة القاسية، ومن إظلامات كل لحظة.. أتركه لخيال القراء. هذه الشابة لم تكن تريد إلا أن تتكلم، أن تتنفس.. حتى لا تختنق.
إني أتعجب في هذا النقص المؤلم في تركيبة المجتمع في بلادنا، ومن المنطق المقلوب في تناول قضايانا المهمة والإنسانية التي هي أس جدار الوطن. حتى الآن يموت أفراد حسرة وضيقا وعذابا لأنهم يختنقون، لا يستطيعون أن يتنفسون، لا يجدون أحدا فقط ليصغي فيتكلمون.. إنك لن تعرف قيمة أن تتكلم عن مشاكلك في الأحوال العادية، ولكن في أحوال الضنك المقيم، والظرف السقيم، والظلم الفاسق، فإن مجرد الكلام والبوح هو نعمة من أحلى النـِعـَم.
ولكنا نرى برامج حوارية عن الأسر تقدمه النساء القشيبات الملمعات اللاتي يعالجن كل الأمور بأرستقراطية واضحة، ولا يلتفتون للمنسيين المعذبين، نرى مراكز الأحياء محلقة بالنشاطات ( المهرجانية طبعا والمظهرية) في الأحياء القادرة، ولا نسمع عن مركز في حي فقير بله أن تتلمس أعماله.. ليست هناك دور ومراكز للأسر.. لذا يموت هؤلاء الناس في حسرتهم، ويختنقون لأنهم.. لا يتكلمون.
آذاننا من زمان تعودت أن تسمع الأصوات التي تأتي من فوق.. فقط!
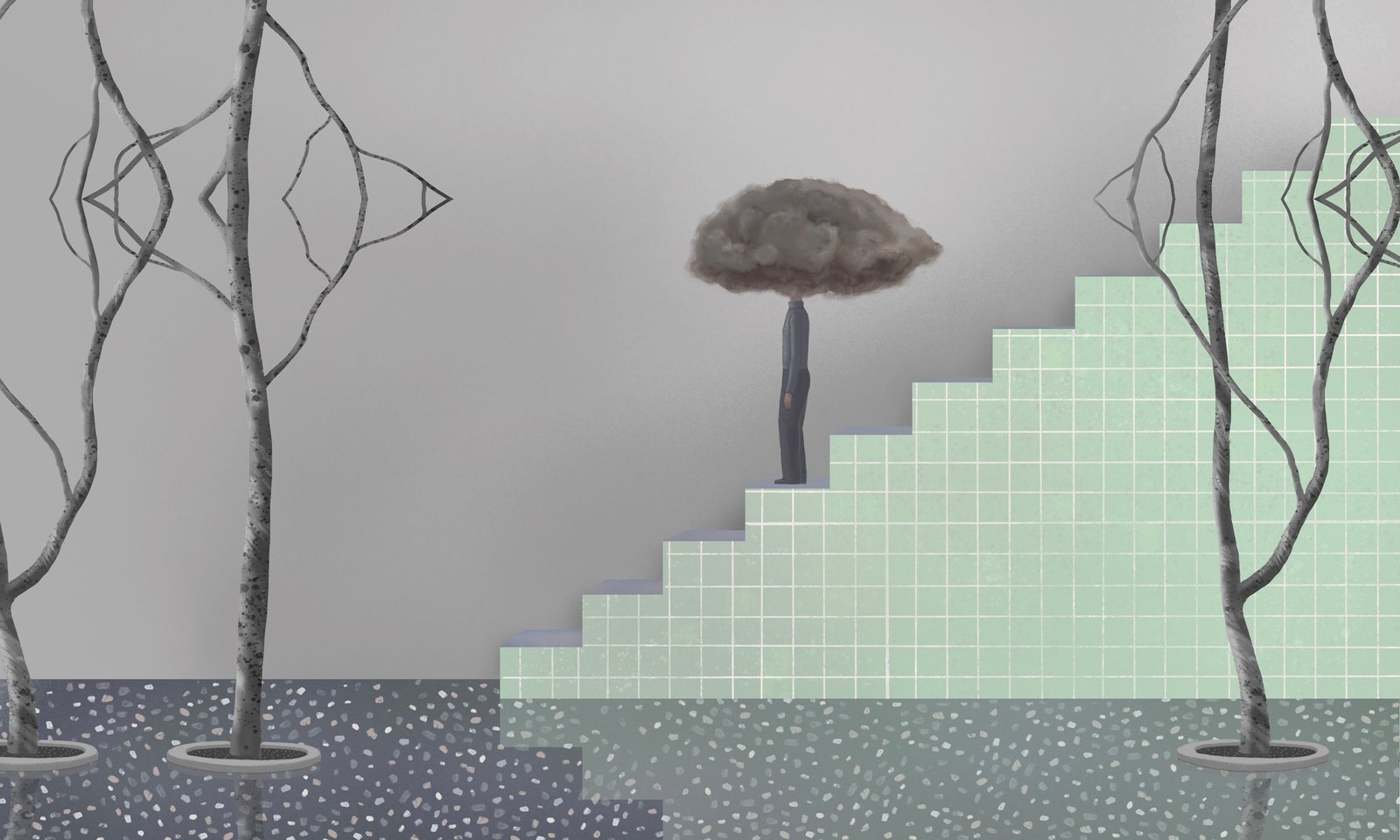
 ألهمني
ألهمني
 مشاركة
مشاركة



